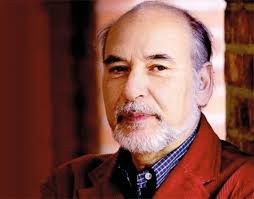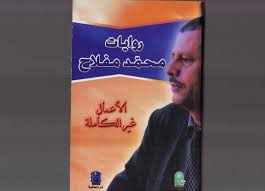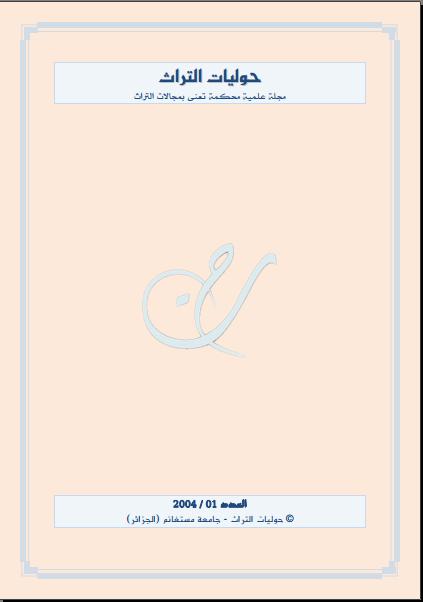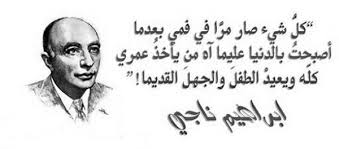عناصر الوحدة الوطنية في الفكر الصوفي
د. رمضان حينوني
تمهيد:
ما من فكرة تنطلق من مبدأ إسلامي أصيل إلا ويكون لها دور في خدمة الإنسان، ذلك أن الله تعالى إنما جعل الدين لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة انطلاقا من عبادته لخالقه وخشيته منه. فالله تعالى عندما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” فإن العبادة كما نظر إليها العلماء تفرعت إلى ضروب كثيرة منها العمل على تحقيق السعادة للإنسان من خلال السعي إلى استقراره وأمنه وحفظ مصالحه.
والتصوف من الأفكار التي اصطبغت بالصبغة الإسلامية على الرغم من الأشكال الصوفية الموجودة في كثير من العقائد والملل وبخاصة في النصرانية. ولقد اختلفت الآراء في الفكر الصوفي بين ناظر إليه على أنه جملة من الأفكار الانهزامية المسنودة بالبدع والخرافات، وبين ناظر لها على أنها صفاء روحي وعلاقة خاصة بين الصوفي وربه، ويبدو أن الصورتين معا شهدتا حضورا في الواقع الإسلامي على مر الزمن، غير أن الصورة الأولى شوهت الثانية إلى حد كبير إلى درجة أصبح فيها مصطلح “التصوف” مثارا للجدل والانتقاد والاتهام، مما دعا كثيرا من المفكرين إلى التأليف في هذه المسألة وتسليط الضوء على حقيقة هذه الظاهرة.
ورغبة في إعادة فكرة التصوف إلى حقيقتها اختار بعض من الدارسين[1] مصطلحات بديلة تأخذ شرعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مثل” الإحسان” أو ” التزكية” من خلال قوله صلى الله عليه وسلم:” الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك” أو التزكية التي تستمد من قوله تعالى:” هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين”[2]. غير أنه إذا كان مصطلح” التصوف” في معنى معناهما وروحهما فلا إشكال فيه وفي تداوله، كما لا قدح في طرقه ومريديه والمنتسبين إليه.
التصوف من الذاتية إلى خدمة المجتمع:
من المهم جدا أن ندرك أن أي إصلاح يبتغيه الفرد لا بد أن يبدأ فيه من ذاته، ثم الأقرب فالأقرب وصولا إلى الجماعة الكبيرة. وإذا استعرضنا مجمل الأقوال التي قيلت في التصوف وجدنا أنه يجمع الزهد والأخلاق والصفاء والمجاهدة والالتزام بالشريعة والعبودية التامة والتسليم الكامل وترك التكلف والاهتمام بالشكليات[3]، وهذه الصفات المتكاملة كفيلة بجعل المرء مستقيما في سلوكه، قدوة لغيره.
يقول أبو الوفاء الغنيمي:” التصوف إذن أولا وقبل كل شيء تجربة خاصة ، وليس شيئا مشتركا بين الناس جميعا”.[4]وعليه، فإنه سلوك ذاتي يبذل فيه الفرد قصارى جهده لبلوغ الصفاء الروحي الذي يشكل المرحلة الأولى في مسار المتصوف وهي مرحلة الفرار من الخلق إلى الحق كما تدل عليه أدبياته. وهكذا يعمل هذا السلوك “على قيام علاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان لا تتحكم بها الغرائز، ولا تسلم قيادتها على الشهوات والجنوح على الاستعباد والإلحاق، فهو يسمو على هذا كله، لأن هدفه الأول والأخير إيجاد الإنسان الفاضل، والظفر برضوان الله وحبه” [5]
أما المرحلة الثانية فهي العودة إلى عالم الخلق بعد إدراك وصفاء، وهذا المسار الثاني هو الذي يقع فيه الاحتكاك بالناس والمجتمع، ويؤدي فيه الصوفي دوره الإصلاحي في أشكاله المختلفة. فالإمام الغزالي مثلا انتقل من الانشغال بالذات إلى الانشغال بالأمة حين كن يرى ما يلحق المسلمين من أدى يسلطه عليهم الجبابرة والظالمون [6] ، إن هذا الانتقال طبيعي؛ فالرسول الأكرم صلَّى الله عليه وسلَّم يقول فيما رواه البخاري يقول:” لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبَّ لنفسه” وإذا كان الصوفي يبتغي الصفاء ونشدان الكمال في التقرب إلى الله، فكيف لا يريد ذلك أيضا للخلق الذين يلتقي بهم ويجالسهم أو يعيش بين ظهرانيهم؟ فالصوفي “يقدّم نفسه- بالإضافة إلى كونه مهذب نفوس مريديه- كمصلح ديني من مهامه تجديد أمر دين هذه الأمة وتبليغ الإسلام إلى الناس وحفظ الروحانية التي تزخر بها شريعة الإسلام، فهو بهذا الاعتبار مربي عام ومربي خاص، فكونه مربيا عاما هو من جهة البلاغ والوعظ، وكونه مربيا خاصا لجهة تهذيب نفوس أتباعه وترقيتهم روحيا. إذن الصوفي الحقيقي ليس هو الذي يعزل نفسه وغيره بين جدران زاويته ويعتني بالرسوم والأوراد من دون العناية بالمجتمع الذي لا يمكن إهماله فالمجتمع هو مجال تفعيل تعاليم التصوف التي يقتضيها القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.”[7]
بل إن الفكر الصوفي يذهب إلى أبعد من ذلك حين يوسع من أفق الاهتمام بالإنسان أو بالآخر وإن كان مختلفا، وهذا” البعد الكوني الشمولي للخطاب الصوفي، بما هو رؤية عالمية روحية تتجاوز المنفعة المادية والتمايز بين الإنسان وأخيه الإنسان على أساس العرق أو اللون أو المعتقد، وصولا إلى التماهي مع صورة المثال المتمثلة بالخالق، والفناء فيه بالمحبة ، ما يسهم في خلق تواصل وحوار حقيقي بين أهل الديانات و الشعوب على قاعدة الاحترام المتبادل ، وقمع الشهوات ، ونبذ العنف، والاصطراع المدمر بين بني البشر.” [8]
وعلى الرغم من بعض السلبيات التي ترتبت عن هذا الانفتاح على الآخر خصوصا في حقب زمنية معينة استغلها الأعداء للسيطرة على عقول المستضعفين، فإن القاعدة في عمومها ليست منحرفة ولا انهزامية، بل لا بد من تثمين وتشجيع تلك ” النزعة الإنسانية العالمية التي بشر بها الخطاب الصوفي، وحب المتصوفة الذي يشمل الإنسانية كلها دون تفرقة بين دين ودين وناس وناس وبلد وبلد” [9] حين لا تضر بالمجتمع ولا تؤدي إلى التنازل عن الخصوصيات العقدية للأمة أي حين تكون منطلقة من وعي وإدراك لأبعاد العلاقة بالآخر لا من غفلة قد تقصر عن إدراك المخاطر المحدقة المحتملة.
إن الاستفادة من الطاقة الروحية للفكر الصوفي ضرورية لنهضة الأمة، وبخاصة إذا كانت منطلقاتها روحية مثل الأمة العربية الإسلامية، وصحيح أننا ” إذا عاشرنا المتصوفة في جميع بقاعهم وعصورهم ودياناتهم وجدنا وحدة الطابع لموقفهم من الحياة … ولوجدنا أنهم دعاة أمن وسلام ومحبة، لا يعميهم التعصب، ولا يحجرهم الجمود ولا يتأبى عليهم تذوق الجمال، ولا تنقصهم الشجاعة وإنكار الذات، ولا تقصر ملكات التفكير فيهم، ولا يفزعهم ما يفزع أغلب الناس، وما أربح الأمة إذا استطاعت أن تستمد من هذه الينابيع طاقتها الروحية التي هي نماذج حية وترجمة واقعية للب الدين وجوهره” [10] .
وإذا علمنا أننا في عصر العولمة وأفكارها وفلسفاتها، أدركنا حاجة الفكر الصوفي إلى النزول بقوة إلى المعترك الاجتماعي ليس لمحاولة الوقوف أمام مد العولمة العاتي، بل ليسخر ما توفره من وسائل للتخفيف من آثارها السلبية؛ خاصة إذا علمنا أن” فئة المريدين في عصر العولمة أصبحت على شروط علمية وثقافية تتجاوز أحيانا قدرات (الزاوية) الفكرية والدينية والثقافية، (والزاوية) بأساليبها التربوية التقليدية والإمكانيات القديمة والمحدودة الأفق قد لا تنهض دينيا وروحيا بهؤلاء المريدين الشباب والكهول الذين قولبت العولمة سلوكياتهم”[11]، والذين ما زالوا يرون في التصوف هو القادر على أن يستوعب ” جميع أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم وأنواعهم ومكانتهم وتوجهاتهم ومشاربهم، وجذبتهم إلى تسامحها وتفسيراتها “المرنة” للدين ونبذها التطرف.”[12]
التصوف والوحدة الوطنية في الجزائر:
الدفاع عن الوطن في حال الخطر:
تضاربت الآراء حول مساهمة الفكر الصوفي في الدعوة إلى الجهاد ضد المحتلين للبلاد الإسلامية عبر العصور، من راء بأنهم انعزلوا عن المجتمع وانقطعوا إلى عباداتهم وطقوسهم، ومن مخالف لهذا الرأي ومثبت بالأدلة التاريخية عكسه. ونعتقد أن مبعث الخلاف هذا إنما يتمثل في التعميم والإجمال وعدم مراعاة الفارق بين التصوف الفلسفي والتصوف العقدي، أو بين تصوف المظهر أو الرسم وتصوف العمق والجوهر.
وحتى إن عرف عن بعض المتصوفة تركهم للجهاد لأي سبب كان، فإن الحجة لا تقام على الفكر الصوفي كله، ففي كل اتجاه ما يشرف وما يجر الخذلان، بحسب ما يحوز الناس عليه من القوة والشجاعة والقناعة بما يفعلون.
وقد لا نجد مثالا أفضل ولا أقرب من الأمير عبد القادر الجزائري في التمثيل لمساهمة المتصوفين في الدفاع عن الأوطان، وجمع أفراد المجتمع صفا واحدا ضد الظلم والاحتلال. يقول شكيب أرسلان فيه:” وكان المرحوم الأمير عبد القادر متضلعا في العلم والأدب، سامي الفكر، راسخ القدم في التصوف، لا يكتفي به نظرا حتى يمارسه عملا… فهو في هذا المشرب من الأفراد الأفذاذ، وربما لا يوجد نظيره في المتأخرين.”[13]
هذا الأمير الفذ هو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وهو الذي رفع راية التحرر من الاستعمار الفرنسي في أول وجوده في الجزائر، وما ذاك إلا لأنه فهم حقيقة أن يرتقي المرء إلى مراتب الحق فينزل إلى الواقع لينظر في حال بلده وإخوانه. إن السعادة التي يبلغها الصوفي نهاية المطاف بعد المجاهدة لا تمنعه من أن يسعى في خلاص الأمة التي ينتمي إليها، فكل ضرر يسكت عنه أو يتقاعس عن رفعه فسيكتوي بناره، فالظلم إذا عم لا يفرق بين الناس وإن لاذ بعضهم إلى الاستكانة والخضوع.
وتذكر مصادر كثيرة أن خيرة أبطال الجزائر قبل الثورة التحريرية كانوا من المتصوفة أو من المتأثرين بالفكر الصوفي؛ من أمثال الشيخ بوعمامة ولالة فاطمة نسومر والشيخ بن جار الله والهاشمي بن علي دردور وغيرهم.
الحفاظ على الهوية الوطنية:
من الطبيعي أن يهتم الفكر الصوفي بالجانب الديني من الهوية أكثر من اللغة، فالمنطلقات والمرتكزات دينية، والأهداف الكبرى كذلك، خاصة في ظل فكرة تقليص الحدود بين بني البشر كما أسلفنا. فهذا الشيخ عدة بن تونس يقول منتقدا التوجه نحو الاهتمام بالعروبة قبل الإسلام:”نرى كثيرا من إخواننا من كتاب اليوم، ينوهون كثيرا بالجنسية العربية، وينسون فضل الإسلام عليها، لأن العرب قبل الإسلام، لم يكونوا إلا أمة مترامية الأطراف في أنحاء الجزيرة العربية… حتى جاء الإسلام، فجمع قلوبهم على الإسلام… وجعلهم أمة تذكر من بين الأمم بأخلاقها العالية: من عدل وشهامة، واقتدار، كل مكتسب من فضل الإسلام على العرب، وعليه ليس من الإنصاف أن ينوه الكاتب بفضل العروبة على الإسلام، متناسيا فضل الإسلام على العروبة.” [14]
غير أن ذلك ليس قدحا في العربية ولا في أهلها، غاية ما هنالك أن الصوفية ترى أن الرابطة الكبرى التي تجمع أفراد المجتمع بطوائفهم وانتماءاتهم المختلفة إنما هي الإسلام، فهو يجمع العربي والأمازيغي والفارسي والحبشي وغيرهم، من حيث لا تستطيع لغة كل منهم أن تقوم بذلك. ولا بأس بعد رابط الدين أن يكتب أو يتكلم أو يتواصل بما شاء من اللغات. ولقد كان الحاج أسعيذ ناف أفليق (دائرة آزفون)، أحد أعلام الشعر الديني الأمازيغي البارزين في النصف الأول من القرن العشرين في الزواوة الغربية، [15]
أما الوطنية وهي الركن الثالث الأساس في بناء الهوية القوي، فلا أحد ينفي عن المتصوفة حبهم أوطانهم ودفاعهم عنها، خصوصا إذا كانت عرضة للمخاطر عملا بمبدأ حب الأوطان من الإيمان عندما تكون ديارا للإسلام.
ولقد تعززت الهوية الوطنية من خلال النشاط التعليمي الذي قامت به الكثير من الزوايا العلمية التي تستقبل الطلاب والزوار والمريدين من جميع أنحاء الوطن، بما توفره من مأوى وإطعام ورعاية ، بمساهمة العمل الخيري والأوقاف التي اعتبرت عبر الزمن شريان الحياة بالنسبة لتلك الزوايا.
إن الهوية الصوفية لا تغطي على هوية الانتماء الوطنية أو القومية غطاء كاملا، بل إن الأولى تفسح للثانية مجالا للبروز بشكل واضح كلما كان ذلك ضروريا، أو كلما تطلبت الظروف ذلك. أي أن الأولى تظل مسيطرة سائدة حتى يستدعي الأمر بروز الثانية فتكشف عن نفسها في أشكال قولية أو فعلية قد تصل إلى حد بذل النفس من أجل ذلك.
خاتمة:
نخلص في نهاية هذه الورقة إلى أن الفكر الصوفي يخضع في تقييمه إلى أحكام نسبية، يجب أن تراعي المنطلقات والمقولات الأصلية أكثر مما تراعي الأشكال والتصرفات الخاضعة للعوامل والظروف الخارجية، وما يعتري هذا الميدان من تداخل مع كثير من التيارات الفكرية والفلسفية. فالفكر الصوفي في بساطته منبع للإصلاح والتفات إلى أهمية الحضور الاجتماعي للشيخ والمريد على حد سواء، حتى تتحقق الأخلاق التي يرتكز إليها الصوفي ويسعى إلى تعميمها.
ولقد استطاعت الزوايا الصوفية في الجزائر في أغلبها أن تدعم مسار الأخوة والتآزر بين أفراد المجتمع، في زمن المحن والشدائد كما في زمن الرخاء والفرج، وما تزال تقاوم العولمة التي تصبو إلى التهام الخصوصيات وانصهارها في فكر القوي اقتصاديا، دونما التفات إلى حاجة المجتمعات إلى هذا الرافد الروحي العظيم، الذي يعد السلم والأمان والأخلاق من أبرز دعائمه.